تم نشر القصة على موقع الجمهورية هنا
حشدَ النظام قواته للسيطرة على اللواء 80، ولكن الثوار كانوا له بالمرصاد. تم الإعلان عن نفيرٍ عام، ومن جملة الذين نفروا أنا ومجموعتي المنضوية تحت راية لواء التوحيد. الطريق طويل باتجاه حلب من مدينة الباب، بعد أن قطع النظام طريق النقارين. ذهبنا من طريق المدينة الصناعية واستلمتُ نقطة رباط في محيط اللواء، وبدأنا بصد هجوم النظام نحن «لواء التوحيد»، مع أحرار الشام وتنظيم الدولة الإسلامية. بعد شهرٍ من الرباط ضد النظام وتمركزه في نقاط جديدة، وبعد أن أوقف تقدمه، كان لا بد من استراحة للمقاتلين، فالاستراحة كيفية! من شروط الانضمام إلى كتيبتي شرطٌ رئيسي هو أن يكون المقاتل «عزابي» غير متزوج، أحياناً ننسى أنفسنا في النقاط على جبهات الرباط.
ركبتُ «بيكام النيسان» الأزرق مع مجموعتي، ووجهتُنا مدينة الباب حيث مقرّنا، أوقَفَنَا حاجز الإنذارات بإطلاق رصاصتين في الهواء.
لم أقف في بداية الأمر، ولكن وقعَ صوت الرصاصتين كان كما لو كأنني أسمعُ صوت رصاص لأول مرة في حياتي، لا أعلمُ لماذا شعرتُ بالخوف، بدون تردد اخذت الطرف اليمين من الطريق، وعبر مرآة السيارة رأيت عنصراً ملثماً ولثامه أكبر من رأسه يتجهُ نحونا، ويصوب بندقيته باتجاه العناصر في صندوق «البيك آب»، ويأمرنا بصوته المرتجف عن بعد عدة أمتار أن ننزل: «الأمير يريد رؤيتنا».
قبل نزولي من السيارة لمعرفة السبب، طلبتُ من العناصر الالتزام بالهدوء ووضع البنادق في وضع الرمي رشاً استعداداً لأي طارئ. اتجه نحونا عنصرٌ آخر أمسكَ فوهة بارودة الشاب صاحب اللثام الكبير، وطلبَ منه التأكد من «هوايا» سيارة أخرى. بلهجته التونسية طلبَ منا ألا نخاف، لأن الأمر ربما يكون سوء تفاهم، وأن لا نلوم الأخ فهو يخاف من تسلل غير محتمل للشبيحة، ثم سألنا: «من أي فصيل أنتم؟».
بصوتٍ جماعي: «توحيد .. شيخ».
لم أعلم ما الذي كان يدور في رأسه من أفكار، وكان واضحاً أنه يعرفُ أننا لا نعلمُ شيئاً. طلب مِنّا اللحاق به، «من بعد إذنكم».. هكذا قال مع ابتسامة لطيفة.
سيارتنا بين سيارتين تابعتين للدولة على الطريق باتجاه المدينة الصناعية، والتونسي يقول إن الأمير يريد رؤيتنا لمدة خمس دقائق فقط لا غير، وأن ثمّة مشكلة صغيرة يريد التأكد منها. أعادَ هذه الجملة علينا أكثر من مرة!، دخلنا إلى معملٍ في المنطقة الثالثة في المدينة الصناعية، وطلبوا منّا الانتظار في الممر لعدة دقائق قليلة لأن الأمير عنده اجتماع.
لم تنته الدقائق القليلة إياها حتى تم تصويب عدة بنادق في وجهنا من أكثر من زاوية، وبصوت مترددٍ من تحت اللثام: «إِنت وهو.. جاثياً ع الأرض بدون ولا أي كلمة»!.
بتحريك جفني طلبت من العناصر الامتثال لأوامرهم، وجلسنا كما أرادوا بدون أي مقاومة. ربما عناصر تنظيم الدولة يريدون المزاح، فلا علم لي أنهم قد يرعبون الناس، وكل الذي أعرفه عنهم أن جبهاتهم الحارة ونقاط رباطهم هي «مطعم عاللولو» على أوتوستراد حلب-الباب، وأنهم لم يؤازرونا لسواد عيوننا في معركة صدّ تقدم النظام في اللواء 80، وإنما لمعرفتهم بخطورة الأمر، وفي حال تقدّم النظام لن يكون مطعم عاللولو بعد الآن.
تم عصبُ أعيينا، وزجوا بنا في منفردات مبنية على عجل، كان لصوتي صدىً في هذا المكان. تلمستُ المكان بيدي، لقد كانت منفردة صغيرة بطول 180 سم وعرض 100 سم تقريباً.
قلتُ بصوتٍ مرتفع: «مين في هون؟ سمعان صوت قروشة! يا شباب حدا يفهمنا شوصاير؟».
ردّ عليّ سجين بصوت يدلّ على أنه مريضٌ بسؤال: «مين أنت؟ وشو تهمتك؟».
– «أنا أبو رسول، أبو رسول النجّار من لواء التوحيد، ما بعرف لشو جابوني لهون!».
– «هون سجن سري للدولة، بس للجيش الحر، ويلي بيضاتهم تقال، وحُكمنا إعدام من الأخير، ما بدنا نأملك بشي!!».
– «ولك شو عم تحكي؟ أنت تف من تمك ولك خاي! مين أنت؟ مع مين تشتغَل؟».
هوَ قائدُ كتيبة خطفه ملثمون منذ فترة ولا أحد يعلم مصيره، كما يوجد إعلاميون وشخصين من ملّاك المعامل الأرمن. كل هذه المعلومات عرفتها في الليل بعد الثانية عشر ليلاً، فهنا ممنوع من الكلام وحتى من الطعام، وجبتان فقط، بيضة مسلوقة مع رغيف خبز يحضرونها لنا بعد صلاة الظهر، و كيس مخلوطة مساءً بين صلاتيّ المغرب والعشاء، مع قنينة كولا فارغة للتبول وكيس للتغوط.
أحدُ السجناء الإعلاميين، أخطأ بين كيس المخلوطة وكيس الغائط، وبين قنينة المياه وقنينة البول، ليترك الأولى ويشرب من الثانية، وأيضاً يأكل من الثانية ويترك الأولى!! وبعد أن مسحَ وجهه بكمّه، أخذ يصرخ بصوت عالٍ ويطرق الباب بقوة.
لا صلاة بوضوء، بل تيممٌ بالحائط فقط. مرَّ شهر، ومن ثم نقلونا مع فجر يوم أحد من معمل إلى معمل آخر، وأمرونا بالجلوس جاثياً في كراج السيارات ريثما يجهز المعمل الآخر، ومن شدة الخوف نطقَ المسجونان الأرمنيان الشهادتين. حضرَ مقاتلٌ وطلب منَّا أن نتربع على الأرض، وقال مازحاً: «لاحقين للبكاء والموت، لما ما يضل ولا دمعة بعيونكم راح نقتلكم».
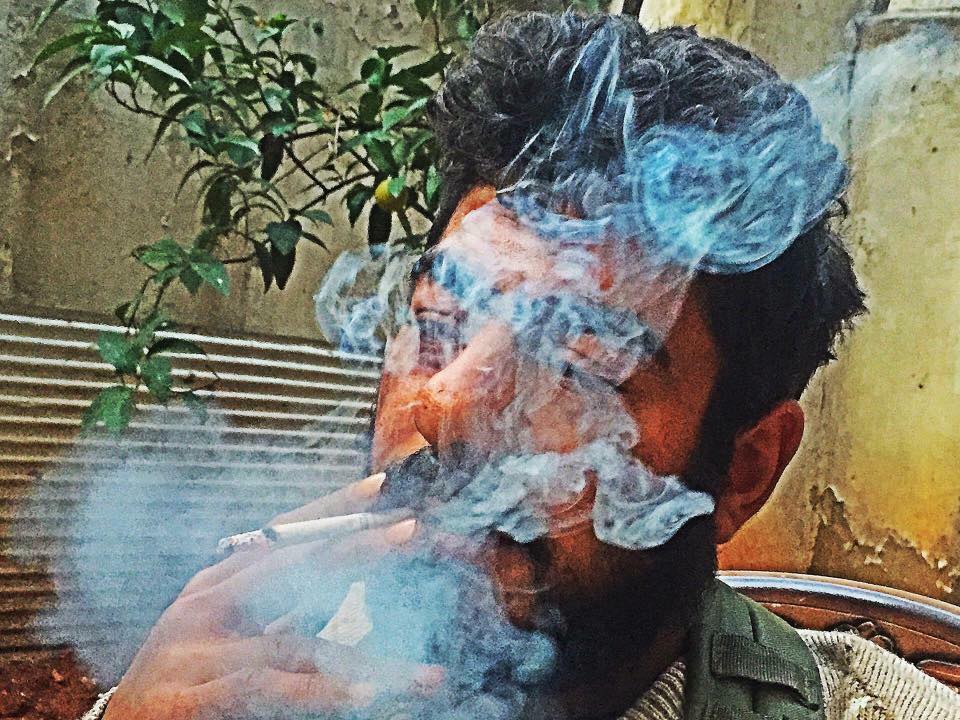
بقينا في المعمل أياماً حتى نقلونا إلى سجن المحطة الحرارية، المرفّه نسبياً بالقياس إلى السجون الأخرى. أمرونا بالاستحمام وصلاة ركعتين توبة لله قبل تنفيذ حكم القتل فينا، ولكن سرعان ما تغيرت قراراتهم. سمعنا بعد منتصف الليل أحدهم يقول لآخر: «ياشيخ تغيّرت اللعبة، جماعة التوحيد يلي اعتقلناهم للاحتياط اليوم صار وقتهم، التوحيد شارك بالمعارك ضدنا واعتقل الأخوة، لذلك لا تقتلوهم وخلوهم تبادل أسرى».
في سجن الحرارية تعرفت على سجناء المنفردات، وبدأنا لعبةً جديدة، وهي أن أغمض عيني وأحاولَ التعرف على الأشخاص من أصواتهم التي كانت تأتيني من وراء جدران المنفردات، صوت قائد الكتيبة مثلاً، كانت نتيجتي خمسة من عشرة.
وضعونا في باص أبيض اللون، وأثناء انتظارنا أوقفوا مسعفاً ميدانياً وسجيناً آخرَ على الحائط، وقتلوهما برصاصتين لإرهابنا اعتقاداً منهم أننا لا نعلم ما هي الخطة، ولماذا لن يتم قتلنا.
قال السائق، وهو شخص سعوديٌ أسود الوجه، لسجانٍ آخر بضحكة خبيثة: «هؤلاء قتلهم في منبج، ومصيرهم كمصير هؤلاء المرتدين»، وأشار بيده إلى المسعف الميداني الذي افترش الأرض مع السجين الآخر.
سارَ الباص باتجاه الشرق بعدما تأكدوا من وجود «الطماشات» على عيوننا، لمحتُ حذائي الأخضر، كنت قد اشتريته بـ 1250 ليرة سورية منذ عشر سنوات من عبّارة المنشية في حلب، لمحته في رجل أمير الأمانات في السجن. لم يزعجني اعتقالي بقدر ما أزعجني الاستيلاء على حذائي الأخضر، هذا الحذاء شارك في معارك ضد النظام تزيد على عدد شعر رأس من يرتديه الآن.
جميعُ عناصر تنظيم الدولة في الباص يرتدون أحزمة ناسفة فلا نستطيع الهرب، ببساطة كبسة زر ونذهب إلى الجنة، ولكنني لا أحلم بالموت على يد المرابطين على جبهة «مطعم عاللولو».
يتضاحكون دون أن نعرف السبب؟!
قال أحدهم:«يا لجبن عناصر الجيش الحر، أسراهم معنا في باص ولا يوقفون الباص حتى! وتقولون لماذا تقدم النظام يا صحوات الردة؟». مررنا من حاجزٍ للجيش الحر على الطريق، ولم يتم إيقاف الباص!! هذا سبب ضحكتهم المصطنعة.
رمونا في المركز الثقافي بمدينة تادف، وأخذوا المعلومات الكاملة عنا وعن أسماء فصائلنا ومنذ متى شاركنا في الثورة وفي حمل السلاح، وكلما كان حمل السلاح أقدم، كلما رسموا قرب الاسم نجمة، وكل نجمة مقابل واحدٍ من معتقليهم عند الجيش الحر.
في المركز الثقافي، علمت أن هناك معارك طاحنة بين الجيش الحر وتنظيم الدولة، وأن مدينة الباب اليوم تحت سيطرة الدولة بعد قتالٍ لأكثر من عشرة أيام. والله من طبيعتي أن آكل كثيراً من الطعام وأسرق طعام غيري في المهجع، ولكن كلما كان يتسرب إلينا خبر مقتل عنصر من عناصرهم، أشعرُ بالشبع وكأنني آكل لحمهم! وكلما عظمُ شأن العنصر كلما كانت الوجبة دسمة، كم فرحت عندما سمعت أن قناصاً واحداً عرقل تقدمهم ليومين!
بعد شهر تقريباً نقلونا إلى سجن المحكمة الإسلامية في مدينة الباب، رمونا في المهاجع وقبل كل صلاة الظهر على مدار شهر، كان يدخل شخص يطلب منا أسماءنا لأن هناك عملية تبادل أسرى خلال يومين فقط.
في النهاية تم تبديل جميع عناصر مجموعتي الذين شبعوا نوماً داخل السجن، حتى عوضوا كل نقص نومهم منذ بداية العمل المسلح، خرجوا مقابل أسرى دواعش عند لواء التوحيد، أما أنا صاحب النجمات قرب اسمي قالوا لي: «كل عناصر كتيبتك يخرجون إلا أنت، فأنت غالٍ ولا يتم تبديلك إلا بعشرة مهاجرين!».
علمت من سجناء جدد، أنه أثناء دخولهم مدينة الباب فجَّر أحد الدواعش نفسه بسيارة مفخخة واستشهد أطفال، تخيلت صورة ابن أخي محمد بين الشهداء، فحسبتها مع نفسي، شخصٌ منهم قتل أكثر من طفل وأكثر من روح بريئة، فكيف عشرة؟!!
قلتُ له دون تردد: «لا شيخي.. أنا بدّي بدالي 20 واحد مو عشرة، أو قلّك 50 وغير هيك ما بطلع من عندكن لو تفتحوا كل البواب قدامي».
لا أحد يهتم بي، فلا أب ولا أم ولا حتى زوجة، كل الذي خفت عليه هو حذائي الأخضر الذي سرقه مني أمير الأمانات، ولا شيء أحزنُ عليه بعد اليوم.
أغلقتُ باب المهجع، وبكيتُ سراً في الحمامات.
انتهى الشتاء وأقبلَ الربيع، وانتهى الربيع وأقبلَ الصيف، ومساجينٌ تخرج ومساجين تدخل، حتى السجانون تغيرت أوضاعهم، من كان بواباً أصبحَ قاضياً، وأنا إلى الآن راضٍ بحظي.
مات جميع المحققين والسجّانين، منهم من قتله الجيش الحر ومنهم من قتله الأكراد. قضينا رمضان ولا يوجد أي عمليات تبادل، ولا بوادر خروج من السجن، ولا حتى إعدام. قضيتُ المدة في صنع «المسابيح» من بذور «العطون» وتعليم المساجين كيفية صنعها، والأدوات تيل ناعم وقصاصة أظافر، وخيط المسابيح إما من كنزاتنا، أو من خيوط السجاد وحصائر المهجع.
قبل «رأس السنة» من سنتي الأولى داخل السجن، تعرضَ سجن الحسبة «السراي» للقصف، وقُطِعت رجل أمير الأمانات الذي سرق لي حذائي الأخضر، ومات متأثراُ بجراحه نتيجة الضربة.
قالوا لنا: «تعلمون من قصف السجن هاااا.. الذي قصف السجن وقتل السجناء هي طيارة اماراتية والتي تقودها أنثى إماراتية والعياذ بالله»، لا أعلم كيف عرفوا نوع الطائرة والطيار!

لا شيء يبدو غريباً على أي حال، عناصرُ الحسبة الجدد يرون لون كحل العين لفتاة تجلس في المقعد الخلفي من باصٍ يمشي بسرعة ٢٠٠ على طريق الباب-حب، إذن هم قادرون على رؤية من قصف السجن، وأن من قصفه هي امرأة إماراتية أيضاً!
بعد قصف سجن السراي، خافَ من لم يَقتُل منهم على الإطلاق (حسب تعبيرهم) على أنفسهم، وعلى إثرها نقلونا مع عدة مساجين إلى سجن الفندق في منبج، وضعونا في فندق بلا نجوم.
– «سجن الباب أرحم من هذا الفندق».
– “بل سجنكم أرحم».
يوجد خدمة «السكرتون» للنزلاء في هذا الفندق، وهي أن يقف النزيل على طوله، ليس في غرفة، بل في مكانٍ أصغر من مرحاض، ويمد يديه خارج البوابة ويغلق عليه عمال الفندق الباب، ليبقى لأيام وأسابيع محصوراً في مساحة 30 × 40 سم، واسألوا من كان بها خبيراً، قدمك تنتفخ وتصبح نمرتها أكثر من خمسين، وتأخذ لوناً أزرقاً مع أسودٍ مع خمري.
أصبحتُ عراب السجن، كل السجناء باختلاف شهاداتهم الجامعية وانتماءاتهم الفصائلية ومدنهم وبلدانهم؛ كلهم يطلبون استشارتي كوني أقدمهم.
أعادوا تجهيز سجن الباب، وتم نقلنا إليه، وبقينا 30 سجيناً فقط من أصل 115 سجيناً. شعرتُ بالوحدة، فقد مات كثيرون وقتلوا، ولم تعجبني نوعية السجناء الجدد، عبارةٌ عن مهربي مازوت ودخان ومرتكبي مخالفات من قبيل التجول في أوقات حظر التجول، قليلون هم أسرى الحرب ومقاتلو الجيش حر.
سجنوا معنا 50 مقاتلاً من الـpkk في مهجع آخر، تسربَ اليأس إلى قلبي وبدأتُ التفكير بالخروج بأي طريقة كانت ولو كلفتني حياتي، فالسجنُ مقبرة الأحياء كما كتبَ سجينٌ من منبج على حائط المهجع.
وأيضاً نوعية الطعام كانت سيئة جداً جداً، خمس «عطونات» لكل سجين: «الله ما قالها». رأيتُ المهجع بعيون ثانية، وتأملت جدران المهجع والشبابيك، يوجد شفاطٌ في الحمامات رأيتُ منه الشارع ونحن في الطابق الأول تحت الأرض. إمّا أن الذي قام بتركيب الشفّاط شخصٌ غبي، أو أنه كان أثناء التركيب خائفاً من أن يُغلقوا الباب وراءَه.
تركتُ صناعة «المسابيح»، وبدأتُ تسليةً أكثر نفعاً لي، الأدواتُ كانت سيخ «فواشة التواليت»، و«حديدة المجلى».
على برميل المياه الأزرق كنت أثبّتُ قدمي، ومع صوت الضجة في النهار كي لا يشعر بعملي أحد، أضعُ حديدة «فواشة التواليت» بين حجر الحائط وحجر الرخام. المطلوبُ هو الحفرُ والمباعدة بين الرخام والحائط ولو عدة سنتيمترات، «تنطعج» حديدة الفواشة فاستخدم حديدة المجلى، وأعدّلُ هذه بتلك على الحائط. كنتُ كلما بدأَ المساجين بالصلاة أدخلُ إلى الحمامات وأبدأ العمل، وكذلك عندما يأكلون، وكلما سمعتُ أحدهم يقترب من الباب، أديرُ نفسي وأجلسُ على البرميل، وللتمويه أقول للسجين، أي سجين كان: «البَرْكِة ع المي تخليني أحس أنو أنا برا السجن».
يقول السجين: «أي والله كلامك صح».
أثناء محاولة المباعدة بين الحجر والرخام في الفترة الصباحية، دخلَ سجينٌ كردي إلى الحمامات معه مرض الإسهال، كاد أن يتسبب لي بجلطة، ولكنه قال بدون أن أطلبَ منه شيئاً: “الله محي أصلك يا أبو رسول، سرّك ببير والله، لا تأكل هم والله يشهد أنه ما رح أقول لحدا وراح ساعدك».
أخذت شهيقاً كشهيق الطفل عند الولادة، وقلت له: «وعد».
«وعد.. أقسم بالله».
رأيتُ عيون المساجين الأكراد تنظر إلي وقت النوم، ويتمتمون بلغتهم الكردية، ربما يكون هذا السجين وعدني أن لا يخبر أحداً بالعربية، ولكنه أخبر المساجين باللغة الكردية!
في طابور الوضوء لصلاة الفجر، اجتمعَ حولي كل الأكراد وعرضوا علي المساعدة: «ما رح نسمحلك تشتغل لحالك وبالأخير نحن نهرب وبدون تعب، يلي يصير عليك يصير علينا والدم واحد، أنت أعطي الأوامر ونحن ننفذ ومتل ما قلك شريكنا، سرك ببيير».
تحولتُ إلى متعهد، أعطي الأوامر وأطلبُ منهم العمل المستمر، وأنا أتربع على المجلى الثانية، بعدما أقنعنا المساجين أن المجلى الأولى كسرها السمين أثناء الوضوء «الله لا يوفقوا». وأطلبُ منهم أحياناً اصطناعَ مشاجرةٍ ورفعَ أصواتهم حتى نستطيع اقتلاع حجرٍ من أحجار الرخام التي يتسبب اقتلاعها بصوتٍ عالٍ. مرَّ أسبوع مليء بالضحك والتعب واسترجاع ذكريات الماضي، وانتهينا من اقتلاع الأحجار وحديد الشفّاط، وحتى نافذة الشبك الخارجية التي أعدناها إلى مكانها بعد أن شممنا رائحة الهواء:
«بالدور يا شباب.. لاحقين تشموه»، شربنا الشاي المخلوط بماء البئر وكأنه اسمنتٌ مجبولٌ يدخل إلى حلقومنا. تربعتُ كالأمير في منتصف المهجع، فأنا أقدمُ وأذكى سجين، ولم أتعلم أياً من الكتب التي كانوا يحضرونها لنا، ويطلبون منا قراءتها. الكل يمسك خدي ويقرصه، ينتظرون مني ساعة الصفر والإعلان عنها، حركة من يدي فقط.
قبل الإعلان عن ساعة الهروب، ذهبتُ إلى اثنين فقط من المهجع لا يعلمون ماذا سيحدث، وهم جواسيس المهجع، وقلت لهم بالحرف: «من فترة أخذوا رفيقكو ودبحوه، ودخل الشرعي وفرجانا صورتو على دوار بمدينة بقرص1، يعني أنتو حكمكن القتل متلنا، بدكون تهربوا معنا أهلا وسهلا، ما تهربوا معنا ندبحكون هون والله ونهرب، صرلنا زمان ما دبحنا حدا وجوعانين دم… مزبوط يا شباب؟».
كل المساجين قالوا: نعم. وافقَ الجواسيس الذين كانوا ينقلوا الأخبار مقابل رغيف خبز إضافي، لكنهم لم يساعدونا خوفاً منا أن نبلغ عنهم!!!
وقفتُ بعد صلاة الفجر أخطبُ بالمساجين، ولكن ليس كأي درس ديني، بل كانت خطبة أعادت الحياة إلى تسعين نفساً: «الهروبُ سيكون في الليل، ولن يهرب أي سجين من مدينة الباب إلا مع سجين من خارج المدينة، فكل بابيٍ سيرافقه سجين غير بابي، سنخرج في الليل لأنه يوجد منع تجول، ونحن بمظهرنا هذا نشبه الدواعش، بل أكثر من الدواعش أنفسهم، لا يوجد ركض، أمشوا بدون خوف، وفي أمان الله».
أنهيتُ خطبتي وودّعنا بعضنا، وسلّم كل واحد مِنّا وصيته لغيره تحسباً. رفعنا آذان العشاء وصلّينا صلاتنا الأخيرة بعد سنة ونصف من الموت البطيء الذي عشته. طلبتُ من سجينٍ أن يفحص الطريق ويتأكد من عدم وجود أي عنصر على سطح المبنى، ثم أمسكت بيد سجين من حلب، وسجينٌ آخر من مدينة الباب أمسك يد سجين من منبج وهكذا، 90 شخصاً تقاسمنا بعضنا بعضاً. كل قافلة تتألف من عشرة مساجين، ودون أي خوف أو ارتباك وكأنني في حرب شوارع، أتوقع في أي لحظة خروج عنصرٍ في وجهي وعلي قتله.
تأكدتُ من خروج المساجين من كافة الفصائل والألوية، وخلال ساعتين كنت في منزل صديق قديم لي، أخبرته في بداية الأمر أنه تم إخلاء سبيلي، وسرعان ما أخبرته بالحقيقة حتى لا يفضح الخبر عن غير قصد، ويأتي الضيوف للترحيب بي.
صباحَ اليوم التالي كانت سيارات الأمنيين في الشوارع تحذّر الأهالي عبر مكبرات الصوت:
«في حال تم إلقاء القبض على سجين في منزل أحدكم، سيكون حكمكم القتل والله، ومن يسلّم سجيناً واحداً له جائزة وعفو أمير المؤمنين». بعد 20 يوماً من السجن الاختياري في منزل صديقي، خرجنا عند الساعة التاسعة صباحاً إلى إحدى المزارع، وبعد شهر تنكرت مع الشاب السجين الذي معي، ولبسنا «الكلابيات والجمدانات» وركبنا سيارةً لنقل العمال إلى مدينة جرابلس بعد التأكد من خلو الطريق من الحواجز الطيارة، وقبل الوصول إلى حاجز مدخل مدينة جرابلس، تسللنا عبر الأراضي الزراعية باتجاه الحدود التركية.
«لا تخاف.. بس خفت راح يمسكوك»، هكذا أخبرت السجين الذي معي، وبعدَ انطلاقِ سيارة الكوبرا التركية، شعرنا أننا عبرنا إلى حياة أخرى وأن الله كتب لنا الحياة من جديد.
عدتُ إلى حلب عن طريق مدينة كلس التركية تهريباً أيضاً، بعد أن بحثت عن أهل الشاب الذي معي وسلمتهم إياه. رجعتُ إلى حلب وشكلت كتيبة من «العزابيين»، وأخذتُ نقطةً في الريف الشمالي ضد الدواعش، ساعياً بكل جهدي إلى أسرِ عناصر منهم، لكي أبادل من استطاعوا أسره بعد عملية الهروب.
